ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻔﻘﻬﻲ وﺣﺠﺠﻪ
الأستاذ يحيى محمد
[ 1 ]
التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلّد الإنسان غيره بها، ومنه يكون المقلّد جاعلاً للحكم الذي قلّد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلّده([1]). وفي أصل الإستعمال يعّرف التقليد بأنه العمل بقول الغير من غير حجة مُلزمة([2])، أو من غير حجة فحسب([3]). ومثاله أخذ العامي والمجتهد بقول مثله. مع ذلك سُمي أخذ المقلّد بقول المفتي تقليداً عرفا([4]ً). وفي هذه الحالة أُعتبر التقليد لدى الذين جوزوه بأنه عمل العامي بقول المفتي بحجة مُلزمة. فهو من هذه الناحية عبارة عن إتباع المجتهد فيما ينتهي إليه نظره دون العلم بدليله على المسألة. وهو باختصار عبارة عن إتباع من هو عاجز عن الفحص لمن هو قادر عليه بالإجتهاد. فمن تعريفاته هو أنه «أخذ فتوى الغير للعمل به». أو أنه تطبيق العمل على فتوى الغير. أو «الإلتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يعمل به بعد، ولا أخذ فتواه»([5]). وقد لقيت هذه التعاريف نقداً من قبل المحقق الخوئي، واستبدلها بتعريف آخر يتناسب مع كل من المفهوم اللغوي والعرفي، فعرفه بأنه «الإستناد إلى قول الغير في مقام العمل»، فيكون معنى تقليد العامي للمجتهد هو أن يجعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه، لا أن معناه الإلتزام أو الأخذ أو غير ذلك مما لا يوافق المعنى اللغوي. وبرأي الخوئي أنه اذا فسرنا التقليد بالإلتزام فسيكون معنى تقليد المجتهد هو أن يجعل العامي فتوى المجتهد وأقواله قلادة لنفسه، لا أنه يجعل أعماله قلادة في رقبة المجتهد. لذلك فالمناسب برأيه هو التعريف الثاني لا الأول([6]). وبنظر السيد محسن الحكيم إن إختلاف التعاريف في معنى التقليد لا يغير من حقيقة وحدة مراد العلماء من أنه العمل بقول الغير([7]). ومن الناحية التاريخية ان التقليد بالمعنى الدال على إتباع قول المجتهد ورأيه، سواء بالأخذ أو العمل أو غير ذلك، لم يكن معروفاً في عصر النص وظلاله. فقد كان الناس في عصر النبي ـ والأئمة ـ والصحابة والتابعين يأخذون معالم دينهم عبر عملية تدعى الإتباع. وهي تعني إتباع أقوال النبي والأئمة وسيرتهم، ولو بصور غير مباشرة من خلال ما يكشف عنها من سيرة الصحابة والتابعين أو من حيث نقل الناقلين. حتى قيل أن الناس آنذاك كانوا لا يتبعون إلا صاحب الشرع، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو معلمي بلدانهم؛ فيمشون حسب ذلك. بل حتى مع ظهور المذاهب وشيوعها إذا وقعت لهم واقعة إستفتوا فيها أي مفت وجدوه من غير تعيين مذهب محدد([8]). وهو أمر وإن كان لا يخلو من تقليد، لكنه ليس تقليداً لشخص بعينه، فربما يراد من ذلك إعتبار الفقهاء تابعين أكثر من كونهم مجتهدين
[ 2 ]
ويبدو أن التقليد باتباع أقوال أصحاب الرأي والإجتهاد من دون تمحيص لم يحدث بصورة واعية إلا بعد وقت متأخر عن عصر التابعين. وعلى رأي إبن حزم إنه لم يكن للتقليد أثر في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، إنما بدأ أول الأمر بعد (سنة 140هـ)، ومن ثم شاع وعمّ بعد المائتين من الهجرة، فندر من لم يلتزم به ويعول عليه([9]). وإن كان قد ذكر في إحدى رسائله أنه حدث في القرن الرابع الهجري([10]). كما جاء في كتاب (أعلام الموقعين) لإبن القيم الجوزية أن التقليد لم يعرف على وجه الضرورة واليقين في عصر التابعين وتابعي التابعين، إنما حدث في القرن الرابع الهجري([11]). فقد قال في معرض ردّه على دعاة التقليد: «إنا نعلم بالضرورة، انه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلاً منهم يقلده في جميع اقواله، فلم يسقط منها شيئاً، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئاً. ونعلم بالضرورة ان هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي التابعين. فليكذبنا المقلدون برجل واحد، سلك سبيلهم الوخيمة، في القرون الفضيلة على لسان رسول الله (ص)»([12]). وأيد الشيخ ابو زهرة كون التقليد ابتدأ منذ القرن الرابع الهجري لكنه كان تقليداً جزئياً ابتداءً، ثم أخذ يتسع نطاقه حتى صار تقليداً كلياً في آخر العصور([13]). على أن هناك فرقاً بين التقليد والإتباع لم يكترث له الكثير من الفقهاء في الساحتين السنية والشيعية، فحسبوه أمراً واحداً، الأمر الذي جعلهم يستدلون على صحة التقليد بالاستناد إلى دليل الإتباع الممارس في عصر الصحابة والتابعين. فالكثير منهم يذكر في معرض تقديم الأدلة على التقليد بأن الناس كانوا يقلّدون الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمة – كما عند الشيعة – بأخذ الفتوى عنهم([14]). بل يسمي البعض حتى الأخذ عن النبي بأنه تقليد، كما هو الحال مع الشافعي، وإن كان يريد بذلك القبول من غير سؤال، ولم يرد ما هو مصطلح عليه([15]). فهو ليس بالتقليد الذي يريده الفقهاء من حيث أنه الأخذ بالرأي، ففارق بين إتباع النص، سواء كان آية أم رواية أو ما يكشف عنه من سيرة، وبين إتباع الرأي الذي هو عبارة عن سلسلة من النظر والتفكير والمماحكة بين الأدلة. فموارد الاتباع ليست موضعاً للاجتهاد المفضي الى الظن بخلاف موارد التقليد. لهذا قال الشيخ ابو محمد المقدسي وبعض الشافعية: «ليس الاخذ بقوله عليه السلام تقليداً؛ لان قوله حجة لما سبق وعرف في مواضعه، والتقليد اخذ السائل بقول من قلده بلا حجة ملزمة له يعرفها»([16]). التقليد بين الحرمة والحلية لم يتفق العلماء – كما هو معلوم – على رأي واحد حول تحديد الحكم الخاص بالتقليد إن كان يجوز أو لا يجوز. فقد ذهب القدماء – وقت ظهور المدارس الفقهية – إلى الحرمة. في حين مال أغلب المتأخرين إلى حليته
[ 3 ]
ونُقل أن السلف ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة كانوا ينهون عن الأخذ عنهم بالتقليد. فقد جاء عن ابن مسعود قوله: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن، وإن كفر كفر. وقال: لا يكن أحدكم إمَّعة يقول: إنما أنا رجل من الناس إن ضلوا ضللت وإن اهتدوا اهتديت. وقال لرجل: لا تقلد دينك أحداً، وعليك بالأثر. وقال المفضل بن زياد: لا تقلد دينك الرجال فانهم لن يسلموا ان يغلطوا([17]). كما جاء عن ابن عباس انه قال: «ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئاً برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله (ص) منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع». ومن ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف: «لا يحل لأحد أن يقول قولنا حتى يعلم من أين قلناه»([18]). أو قوله: «حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي»([19]). وقول مالك: «إنما أنا بشر أُخطئ وأُصيب فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»([20]). وما اشار اليه الشافعي في رسالته([21])، وكذا ما قاله: «مثلُ الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل، يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري»([22]). وقد نقل إسماعيل بن يحيى المزني عن الشافعي أنه كان ينهى عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه([23]). وجاء عن إبن حنبل إنه قال: «لا تقلّد في دينك أحداً… ما جاء عن النبي (ص) وأصحابه فخذ به، ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير»([24]). وهو بذلك يفرق بين التقليد والإتباع. كما جاء عنه قوله: «لا تقلّدني ولا تقلّد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا»، وقوله: «من قلة فقه الرجل ان يقلّد دينه الرجال»([25]). وقد شاع عن ابن حنبل ومذهبه عدم اقرار التقليد وان لكل انسان وسعه في الاجتهاد؛ خلافاً لما حصل لدى المذاهب الثلاثة الاخرى([26]). وكذا الحال مع مذهب الظاهرية التي أوجبت الاجتهاد على الكافة بمن فيهم العامة من الناس([27]). وقد كان ابن حزم يرى ان على كل من العامي والعالم حظه الذي يستطيعه من الاجتهاد([28]). وجاء عن عبد الله بن المعتمر قوله: «لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلّد»([29]). ونقل القرافي المالكي أن مذهب مالك وجمهور العلماء هو أنهم يقولون بوجوب الإجتهاد وإبطال التقليد([30]). ومما يُذكر بهذا الصدد أنه كان مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى إبن هرمز، فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما، وإذا سأله إبن دينار وذووه لم يجبهم، فتعرض له إبن دينار يوماً فقال له: يا أبا بكر لِمَ تستحل مني ما يحل لك؟ فقال له: يا إبن أخي وما ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما وأسألك أنا وذووي فلا تجيبنا؟ فقال: أوقع ذلك يا إبن أخي؟ قال: نعم، قال: إني قد كبرتْ سني ودقّ عظمي، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني، ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمعا مني حقاً قبلاه وإن سمعا خطأً تركاه، وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه([31]). كما ذُكر أنه إضطجع ربيعة يوماً مقنعاً رأسه وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رياء ظاهر وشهوة خفية والناس عند علمائهم كالصبيان في إمامهم؛ ما نهوهم عنه إنتهوا، وما أُمروا به إئتمروا([32]). لكن في القبال نُقل عن بعض المتقدمين ما ظاهره جواز التقليد، كقول محمد بن الحسن
[ 4 ]
ـ«يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله»([33])، كذلك قول الشافعي في أكثر من موضع: قلته تقليداً لعمر.. وقلته تقليداً لعثمان.. وقلته تقليداً لعطاء([34]). لذلك روي عن الشافعي في رسالته القديمة أنه كان يجيز تقليد أيٍّ من الصحابة دون من سواهم. كما نُقل عن إبن سراج قوله: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه إذا تعذّر عليه وجه الإجتهاد. بل روي عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري قولهم بجواز تقليد العالم للعالم مطلقاً. كما نُقل عن أبي حنيفة روايتان. ونُقل عن بعض أهل العراق قوله بجواز تقليد العالم فيما يفتي به وفيما يخصه([35]). ولا شك ان بعض هذه الأقوال دالة على صحة التقليد حين العجز عن الوصول إلى حقيقة موقف الشرع، كما هو الحال مع قول الشافعي، اذ سبق أن عرفنا بأنه لا يقر التقليد مبدئياً. لذلك سوّغ إبن القيم الاضطرار الى مثل هذه الحالة من التقليد، ورأى أن غاية ما نُقل عن أئمة المذاهب هو أنهم قلّدوا في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله، ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلّدوه. وقد عدّ هذه الطريقة هي فعل أهل العلم، وبالتالي فهي الواجبة لأن التقليد إنما يباح للمضطر([36]). لكنه من الناحية المبدئية لا يرى جواز تقليد أحد، بل ذهب كما ذهب إبن حزم بأنْ تُعرض أقوال الرجال على الكتاب والسنة ويؤخذ ما يوافقهما ويُعرض عما يخالفهما، معتبراً ذلك مما أمر الشرع به([37]). فبرأي ابن حزم ان العامي والعالم في ذلك سواء، وعلى كل واحد من الناس حظه من الاجتهاد بحسب وسعه، وخطاب الله للناس جميعاً دون تمييز بين عالم وعامي ((وما كان ربك نسياً))([38])([39]). أما المتأخرون من الفقهاء فأغلبهم مال إلى جواز التقليد، بينما ذهب القليل منهم إلى التحريم، كإبن حزم في مختلف كتبه، وإبن تيمية وتلميذه إبن القيم، وقد ذكر الاخير في (اعلام الموقعين) واحداً وثمانين وجهاً على بطلان التقليد([40])، وكذا الحال مع أبي عبد الله بن خواز منداد البصري المالكي الذي عرّف التقليد بأنه الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وهو ممنوع في الشريعة، على خلاف الإتباع الذي عدّه مما ثبتت عليه الحجة([41]). ومما قاله بهذا الصدد: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ، والتقليد ممنوع([42]). وكذا هو رأي الامام الشوكاني كما في رسالته (القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد) وما بحثه في الفصل الثاني من كتابه (إرشاد الفحول)([43]). كما نُقل عن جمع من معتزلة بغداد أن العامي لا يجوز له أن يقلّد أو يأخذ بقول أحد إلا أن يبين له حجته([44]). وابلغ من شدد على ابطال التقليد هو ابن حزم، سواء في العقيدة او الفقه، اذ رفض تقليد الأئمة والمذاهب جميعاً، ورأى انه لا فرق بين من قلّد هذا الإمام أو المذهب أو ذاك، بل جعل الإجتهاد نصيب الكل، وواجباً على الجميع، كلاً بحسب طاقته، ولو أدى ذلك إلى الخطأ في الإجتهاد، فهو يفضله على التقليد مع الصحة، وهذا الامر يشمل عنده حتى الرجل العامي. فعلى حد قوله
[ 5 ]
ـ«من إدعى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد إدعى الباطل وقال قولاً لم يأت به قط نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، وما كان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا دليل». بل على العكس رأى أن «التقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخرها؛ من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام». لذا فهو بالتالي يحرم تقليد أئمة المذاهب الأربعة والصحابة ومن على شاكلتهم، فصرح بالقول: «وليعلم أن كل من قلّد من صاحب أو تابع أو مالكاً وأبا حنيفة والشافعي وسفيان والأوزاعي وأحمد – إبن حنبل – و– داود – الأصبهاني رضي الله عنهم؛ إنهم متبرأون منه في الدنيا والآخرة». كما أنه ردّ على من يتمسك بالتقليد بقوله: «ما الفرق بينك وبين من قلّد غير الذي قلّدت أنت، بل كفّر من قلّدته أنت أو جهله، فإن أخذ يستدل في فضل من قلّده كان قد ترك التقليد وسلك في طريق الإستدلال من غير تقليد»([45]). *** أما في الإتجاه الشيعي فقد مال غالبية العلماء، خصوصاً المتأخرين، إلى حلية التقليد، بينما ذهب القليل منهم إلى تحريمه صراحة، كإبن زهرة الذي أعلن ذلك بقوله: «لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي، لأن التقليد قبيح، ولأن الطائفة مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بعلم. وليس لأحد أن يقول قيام الدليل وهو إجماع الطائفة على وجوب رجوع العامي إلى المفتي والعمل بقوله مع جواز الخطأ عليه يؤمنه من الإقدام على القبيح ويقتضي إسناد عمله إلى علم؛ لأنا لا نسلم إجماعها على العمل بقوله مع جواز الخطأ عليه، وهو موضوع الخلاف. بل إنما أمروا برجوع العامي إلى المفتي فقط، فأما ليعمل بقوله تقليداً فلا. فإن قيل: فما الفائدة في رجوعه إليه إذا لم يجز له العمل بقوله؟ قلنا: الفائدة في ذلك أن يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الإمامية سبيل إلى العلم بإجماعهم فيعمل بالحكم على يقين»([46]). وجاء في كتاب (الذكرى) للشهيد الأول أن تحريم التقليد كان إعتقاد بعض الأصحاب وفقهاء حلب([47]). ووافقهم على ذلك من المتأخرين جماعة من الإخبارية على رأسهم مؤسس المذهب محمد أمين الإسترابادي، وتابعه آخرون على رأسهم الحر العاملي صاحب (وسائل الشيعة)([48]). كما نقل الشريف المرتضى طعن قوم في صحة الإستفتاء، وأن على العامي أن يكون متمكناً من إصابة الحق في الأُصول والفروع، وإذا لم يتمكن فهو خارج عن التكليف؛ فلا محرم عليه ولا واجب، بل حكمه حكم البهائم. لكن المرتضى لم يشخّص من هم هؤلاء القوم الذين حرموا الإستفتاء، فهل يعودون إلى جماعة من الطائفة الإمامية الإثني عشرية أم إلى غيرها([49]). وجاء عن الشيخ الطوسي – المعد أول من فتح باب الإجتهاد المطلق – ما ظاهره تحريم التقليد، كما في كتابه (تلخيص الشافي)، فبعد تقريره بأن القياس وأخبار الآحاد والإجتهاد لا يجوز التعبد بها؛ عاد فقال: «إن العامي لا يجوز أن يقلّد غيره، بل يلزمه أن يطلب العلم من الجهة التي تؤدي إلى العلم»([50]). وإن كان نصّه هذا لا يدل على التحريم المطلق، فربما كان مراده أن
[ 6 ]
الأصل لا يجوز التقليد فيه، وهو متفق عليه وإلا دار الأمر أو تسلسل، كما قد يكون مراده ما يخص العقائد بقرينة أن البحث الذي كان يبحثه إنما يتعلق بالإمامة. أما الشريف المرتضى وإبن إدريس الحلي فمن حيث انهما يمنعان من الظن في الأحكام الشرعية صراحة؛ فربما لهذا يذهبان إلى تحريم التقليد ما لم يفضِ إلى العلم أو القطع، مما يعد عائداً إلى الإتباع أو أنه متسق معه. فالشريف المرتضى يجيز إستفتاء العامي للعالم، لكنه حيث يمنع من الظن في الأحكام الشرعية؛ لذا فقد يكون معولاً في الإستفتاء على الإتباع لا التقليد المصطلح عليه، أي أنه يجيز إتباع العامي للعالم إذا ما إطمأن انه يحكي مفاد الشرع بالعلم لا الظن([51]). أدلة التقليد يمكن القول طبقاً للنصوص الكثيرة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة وذم الرأي والظن، إن الأصل في التقليد، من حيث أنه إتباع آراء الرجال على سبيل الظن، هو عدم الجواز، وذلك ما لم تكن هناك ضرورة وإضطرار؛ للقصور والعجز عن الوصول إلى معرفة الأحكام لدى الذين لم يدركوا عصر النص ولم يتمكنوا من الإجتهاد. فالتقليد كالإجتهاد كلاهما لا يصحان لولا الإضطرار والضرورة التي فرضها غياب قرائن العلم نتيجة الإبتعاد عن عصر النص وبُعد الزمان وظهور الوقائع الجديدة. والفارق بينهما هو أن التقليد متوقف على الإجتهاد، فلولا هذا الأخير ما كان الأول، والعكس ليس صحيحاً، اذ أن الأخير ليس متوقفاً على الأول. يضاف إلى أن الإجتهاد متقدم على التقليد، اذ لو كان الفرد متمكناً منه لما جاز عليه أن يتبع قول غيره. فعقلاً إن من غير المنطقي أن يأخذ الفرد برأي غيره وهو يراه خطأً. بينما يُفترض في المقلّد أن لا يكون له رأي خاص من الناحية العلمية، وبالتالي فليس له وظيفة سوى إتباع من هو أهل للإختصاص. وأقرب ما جاء من النقل على تحريمه ما رواه الترمذي وابن عبد البر عن عدي بن حاتم عن النبي (ص) وهو يكشف عن معنى قوله تعالى: ((إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله))، حيث قال (ص): «إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً إستحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرّموه»([52]). وهو المعنى المروي في المصادر الشيعية، كما عن الإمام الصادق (ع)([53]). لكن الذي يبرر جواز التقليد هو كون أكثر الناس ليس بوسعهم ممارسة الإجتهاد والإختصاص في ميدان الفقه، اذ تحتاج العملية إلى نوع من التفرغ لا يحصل إلا بتقليص النشاط في سائر نواحي الحياة وميادينها. وبالتالي فمن المحال على الناس أن يكونوا كلهم مجتهدين، والا
[ 7 ]
أصبحت الحياة معطلة وعسيرة لا تطاق، لأنها تحتاج إلى ما يشغلها من الممارسات الحياتية الأُخرى كما هو واضح. ومن المبالغ به ما صوّره دعاة نفي التقليد من أن عملية معرفة الأحكام سهلة يسيرة يمكن أن يزاولها أيّ فرد مسلم. اذ ذُكر أن أُصول الأحكام عبارة عن خمسمائة حديث تقريباً، وتفاصيلها تبلغ حوالي أربعة آلاف حديث، وأن المسلم ليس بمكلف أن يعرف إلا ما يخصه من الأحكام ولا يجب عليه معرفة ما لا تدعوه الحاجة، وبالتالي فليس هناك من تضييع لمصالح الخلق وتعطيل معاشهم([54]). ومثل ذلك ما ذهب إليه الإخباريون في الإتجاه الشيعي من وجوب التعويل على ما هو مدوّن في الكتب الشيعية المعتبرة وعلى رأسها الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، وهي كتاب (الكافي في الأُصول والفروع) للشيخ الكليني (المتوفى سنة 328هـ)، وكتاب (من لا يحضره الفقيه) للشيخ الصدوق (المتوفى سنة 381هـ)، وكتابا (التهذيب والإستبصار) للشيخ أبي جعفر الطوسي (المتوفى سنة 460هـ). والواقع أن وجود التعارض في الأخبار والملابسات التي تكتنفها مع مشاكل السند والمتن؛ كل ذلك يجعل من الصعب على المسلم العادي أن يبلغ مرتبة الإجتهاد والإختصاص، وإن كان بإمكانه أن يزاول طريقة أُخرى لا تمت إلى التقليد بصلة، وهي طريقة النظر. أما من حيث أدلة التقليد فيمكن القول أنه لا يوجد دليل من الأدلة التي قُدمت لإثبات جوازه إلا وهو دخيل وقابل للطعن، سواء تلك المستمدة من الكتاب أو السنة أو دعوى الإجماع أو ملاحظة السيرة العقلائية أو غير ذلك. حتى أن البعض ممن جوّز العمل به قد ضعّف أغلب أنواع تلك الأدلة، ولم يعثر على دليل مباشر مستمد من الشرع، كالشيخ المنتظري الذي إعتبر العمدة في قبوله هو البناء العقلائي، بل إنه لم يعد ذلك تقليداً على ما سنرى. كما أن الآخوند الخراساني هو الآخر إعتبر ذلك البناء هو العمدة، أما ما عداه فأغلبه قابل للمناقشة([55]) الأدلة السنية ومناقشتها قدم علماء الإتجاه السني عدة أدلة على جواز التقليد، وذلك من الكتاب والسيرة والإجماع والعقل. فمن الكتاب إستدلوا بقوله تعالى: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))([56])، اذ أُعتبرت الآية عامة في السؤال لكل ما لا يُعلم، أو من حيث أن فائدة السؤال هو إتباع أهل الذكر أو العلماء، وهو المعبّر عنه بالتقليد([57])، مع أن الآية ليست بصدد التقليد ولا الأُمور الفرعية، انما بصدد إثبات النبوة كما يُنبئ عن ذلك صدر الآية: ((وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))([58]). بل حتى لو سلمنا أنها واردة في عموم السؤال فلا دلالة لها على الأخذ بآراء الرجال، إذ كل ما يظهر منها هو طلب العلم بالإستعلام عن حكم الله لا الظن الذي يفضي إليه الرأي والإجتهاد
[ 8 ]
ومن الإجماع والسيرة إستدلوا بكون العامة من الناس في زمن الصحابة والتابعين لا يتوقفون عن إستفتاء الفقهاء وإتباعهم في الأحكام الشرعية، وقد كان العلماء يبادرون إلى الإجابة دون نكير، مما يعني أن الإجماع قائم على جواز إتباع العامي للمجتهد مطلقاً([59]). ويبدو أن هناك لبساً بين التقليد والإتباع، فلا شك أن الإتباع لا خلاف عليه، من حيث أنه أخذ بالرواية او مضمونها الكاشف عن الشرع، وقد يدّعى في شأنه الإجماع. أما التقليد فالأمر يختلف، اذ هو عبارة عن إتباع الرأي الكاشف عن مراد الشرع بالظن، وهذا ما لا دليل على حصول الإجماع في جواز العمل به. اذ كل ما هو معلوم أن الأُمة وقت الصحابة والتابعين كانت تتبع العلماء لمعرفة شؤون دينها؛ فإما أن يكون عملها هذا هو نفس ما يُطلق عليه الإتباع من حيث إنه كاشف عن مضمون الشرع بالعلم والإطمئنان، أو هو عبارة عما يُطلق عليه التقليد من حيث إنه إتباع للرأي المظنون. ومن الناس مَن يتبع العلماء المجتهدين وهو يتصور أن إستنباطاتهم لا تعبر إلا عن العلم واليقين بمراد الشرع، كما يحصل اليوم لدى اغلب العوام من الناس، فما بالك في الزمن القريب عن عصر النص؟! لهذا فالمتصور أن الناس في ذلك الزمان على أشكال؛ فبعضهم يقتفي أثر الإتباع في أخذ الرواية والحديث، وبعض آخر يكتفي بمضمون الحكم الشرعي من حيث هو حكم الشرع، وبعض ثالث يبادر إلى السؤال عن المصدر ودليل القول بالفتوى، وبعض رابع يتبع العالم المجتهد إعتقاداً بكونه مدركاً للحكم الشرعي على نحو العلم والقطع. لكن من المستبعد أن نجد في ذلك الوقت أحداً يتبع المجتهد وهو يعتقد أنه يعمل بالرأي الذي يفضي إلى الظن، إلا إذا افترضنا أنه لم يجد من يفتي في مسألته سواه. لهذا فبالرغم من أن زمن إبن حنبل متأخر عن تلك الفترة فانه مع ذلك كان يرجح الأخذ بضعيف الحديث على الأخذ بالرأي. فقد سأله ابنه عبد الله فيما لو لم يجد الرجل إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأي، فتنزل به النازلة ماذا يفعل؟ أجابه ابن حنبل: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من الرأي([60]). على ذلك فما يؤاخذ عليه القائلون بدليل الإجماع في سيرة الصحابة والتابعين هو أنهم لم يميزوا بين الإتباع والتقليد، وكأنهم جعلوا كل ما عنوانه إتباعاً بحسب الإصطلاح يفيد التقليد الذي إتخذوه عنواناً عاماً يشمل المفهومين المتمايزين معاً؛ حتى طبقوه – أحياناً – على إتباع قول النبي. كذلك إستدل العلماء بدليل الإنسداد العقلي، حيث أن من ليس له أهلية الإجتهاد إما أن لا يكون متعبداً بشيء من الفروع والجزئيات التي عليها مدار الإختلاف، أو أنه متعبد بها، لكن الفرض الأول لا يصح بلا خلاف، وأن من صفته التعبد لا يصح مطالبته بالنظر في أدلة الحكم والإجتهاد؛ باعتبار أن هذا يشغله عن المعاش وبالتالي تتعطل الصنائع والحرف ويتحقق بذلك الحرج والضرر المنفي في قوله تعالى: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج))([61])، وبهذا
[ 9 ]
يثبت جواز التقليد([62]). والواقع أن هذا الدليل يصح من حيث الإضطرار كما نبهنا على ذلك في أول الحديث، لكنه لا يصح على إطلاق، طالما هناك طريقة وسطى بين الإجتهاد والتقليد نطلق عليها (النظر). وقد وجدنا بعض الفقهاء المتأخرين من أشار إلى وجود فئة يمكن أن تتوسط بين طبقتي المجتهدين والمقلّدين، كما هو الحال مع الإمام الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول)([63])، وإن كانت إشارته عابرة وقاصرة. الأدلة الشيعية ومناقشتها أما الأدلة التي قدمها الإتجاه الشيعي على صحة التقليد فهي كالآتي: دليل الكتاب من الأدلة التي أُقيمت لإثبات جواز التقليد ما أفاده البعض من آية الانذار: ((وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون))([64]). فكما يُذكر أن في الآية قولين: أحدهما أن معناها هو لولا نفر من كل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه القاعدة وتنذر النافرة للجهاد إذا رجعوا إليهم، فيخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي، وهو قول الأكثر([65]). ولا شك أنه ليس لهذا القول علاقة بالتقليد؛ لا من قريب ولا من بعيد. أما القول الآخر فيرى أن معنى الاية هو لولا نفر من كل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة، فيكون المعنى في طلب العلم، وهو قول الشافعي وجماعة من المفسرين، وهو كذلك مدار البحث لدى العلماء القائلين بالتقليد. فقد إستدل البعض بأنه يفاد من الآية وجوب الحذر حين الإنذار الذي يبديه الفقيه، وحيث أن الآية أطلقت دون جعل الحذر مقيداً بحصول العلم من إنذار المنذرين؛ لذا فإن الحذر واجب عقيب الإنذار؛ سواء حصل العلم للمتحذر أم لم يحصل. وبذلك تدل الآية عند هذا البعض على وجوب التقليد في الأحكام لوجوب الحذر بإنذار الفقيه، وبالتالي إتباع فتواه حتى لو كانت ظنية([66]). على أن صحة هذا الدليل أو بطلانه تتوقف على الافادة التي تفيدها الآية بخصوص الإجتهاد
[ 10 ]
فالذي إعتبر الآية دالة على الاجتهاد علماً وظناً فإن بإمكانه أن يستدل بها على التقليد أيضاً. في حين ان من لم يرَ في الآية هذه الدلالة على الإجتهاد المفضي إلى الظن؛ فإنه لا يمكن أن يستنبط منها الحكم بجواز التقليد. وسبق أن عرفنا بأن الآية لا تبدي الإطلاق اللفظي من حيث وجوب الحذر وإتباع أخذ الفتوى من الفقيه علماً وظناً، بل ظاهرها التقييد بالعلم، لأن خطاب الآية ليس منفصلاً عن سائر النصوص التي تحث على العلم وتنهى عن الظن، وهو أمر يؤكده حال التعامل في عصر النص. لذلك لا مجال للتعميم والتعويل على الإطلاق اللفظي. ويؤيد هذا ما ذكره الآخوند الخراساني في (الكفاية) من أنه ليس لدلالة هذه الآية ولا آية السؤال على جواز التقليد؛ لقوة إحتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم، لا الأخذ بالتقليد والظن تعبداً([67]). ومما يقوي كون هذه الآية ليست بصدد جعل الحجية التعبدية للرأي والظن؛ ما ورد في تفسير الإمام الصادق لها بقوله: «فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله (ص) فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم»([68]). فبحسب هذا الحديث أن العبرة بأخذ العلم، ثم بعد ذلك تعليمه وإذاعته بين الآخرين، وليس في ذلك دلالة على الظن ولا الرأي والإجتهاد. كما استدل العلماء على جواز التقليد بآية السؤال أو الذكر، مع أن الآية ليس لها دلالة على هذا المورد. لذلك لم يعول عليها العديد من العلماء القائلين بجواز التقليد([69]). دليل الأخبار هناك الكثير من الأخبار الدالة على حجية إتباع الناس للعلماء من حيث إبلاغهم العلم والفتوى عن الشرع، وقد فهمها المتأخرون بالمعنى الدال على التقليد، حتى جعلها البعض مخصصة لدلالة الايات والروايات على حرمة إتباع غير العلم وذم التقليد، كما هو الحال مع الآخوند الخراساني([70]). فالأخبار التي وردت بهذا الصدد على أشكال: منها ما يتعلق بمدح العلماء والرواة باعتبارهم يقومون بتبليغ الأحاديث وبيان الأحكام الشرعية، ولازمه القبول عنهم. ومن ذلك ما روي عن الإمام الرضا عن آبائه (ع) ان رسول الله (ص) قال: اللهم إرحم خلفائي – ثلاث مرات – فقيل له: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون عني أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي([71]). وفي (معاني الأخبار) عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت الرضا (ع) يقول: رحم الله عبداً أحيى أمرنا. فقال: وكيف يحيي أمركم؟ قال (ع): يتعلم علومنا ويعلمها الناس([72]). ومنها ما يتعلق بحَثّ الناس إلى الرجوع إليهم فيما لا يعلمون، سواء كان عموماً أو تشخيصاً
[ 11 ]
ومن ذلك ما روي عن أحمد بن اسحاق أنه سأل أبا الحسن (ع) وقال: من أُعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال (ع): العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. قال وسألت أبا محمد (ع) عن مثل ذلك، فقال: العمري وإبنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان([73]). كما أن منها ما يتعلق بالترغيب في الإفتاء، ولازمه قبول فتاواهم، وفي بعض الأخبار أن الإفتاء الجائز هو ذلك القائم على العلم لا غير. ومن تلك الأحاديث ما روي عن أبي عبيدة عن الامام أبي جعفر (ع) انه قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه([74]). كذلك منها ما دل على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء وإيجاب القبول لحكمهم. ومن ذلك ما روي عن أبي خديجة أن الإمام الصادق قال: إجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضياً، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر([75]).. إلى غير ذلك من الروايات. والملاحظ أن جميع طوائف هذه الروايات لها دلالة على الإتباع المستند إلى العلم دون الظن، وليس لها دلالة على التقليد المنبني على إتباع ظن المجتهد تعبداً. فأقربها علاقة بالموضوع تلك المتعلقة بحثّ الناس على الرجوع إلى الفقهاء، مثل توقيع الحجة: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم»، لكن الرواية ضعيفة، حيث رواها إسحاق بن يعقوب وهو مجهول الحال، وجاء في السند محمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقته هو الآخر، إضافة إلى أنها دالة على الرجوع إلى الرواة لا المجتهدين. كذلك ما ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع)، اذ فيه الرواية الوحيدة التي تتعلق بالتقليد مباشرة: «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم»([76])، إلا أن الرواية ضعيفة ومرسلة، حيث فيها عدد من المجاهيل، يضاف إلى أنها وردت بخصوص نقد عوام اليهود وتقليدهم([77]). بل نظراً إلى سائر النصوص التي تأخذ العلم كقيد في الإتباع فإنه لا بد من حمل لفظة التقليد في الرواية – على فرض صحتها – على إتباع ما يفيد العلم لا الإجتهاد المفضي إلى الظن. أما الروايات المتعلقة بإرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء؛ فإضافة إلى أنها تريد بالفقهاء الرواة المميزين، فكذلك لا دلالة لها على التقليد، للفارق بين قبول القضاء وبين أخذ الفتوى، إذ التعدي من الباب الأول إلى الآخر وقياس أحدهما عليه يتوقف على إلغاء خصوصية القضاء عن الفتوى والقطع بعدم تأثيرها، مع أنه في القضاء لا بد من حل النزاع بالحكم ولو كان ظناً، أما مع الفتوى فالأمر مختلف اذ لا نزاع. ومع ذلك فبعض ما ورد في هذا الباب يُعد من الروايات
[ 12 ]
الضعيفة، كمقبولة عمر بن حنظلة وما على شاكلتها. هكذا يظهر أن جميع طوائف الروايات المشار إليها لا علاقة لها بالتقليد، اذ ليس لها معنى محصل سوى الدلالة على الإتباع، والفرق بينهما كبير على ما سبق أن بيّنا. دليل السيرة العقلائية يظل أن العمدة في أدلة جواز التقليد لدى الفقهاء هو بناء العقلاء وسيرتهم مع أخذ إعتبار عدم ردع الشرع لذلك، حيث أن جواز رجوع الجاهل إلى العالم من الضرورات التي لم يختلف فيها إثنان، وهو أمر مركوز في الأذهان وثابت ببناء العقلاء في جميع العصور والأزمنة([78]). فعلى حد قول الآخوند الخراساني: «يكون بديهياً جبلياً فطرياً لا يحتاج إلى دليل، وإلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقاً – في الغالب – لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتاباً وسنة، ولا يجوز التقليد فيه أيضاً، وإلا لدار أو تسلسل»([79]). وهذا الحد عند الخراساني هو العمدة في الأدلة، وماعدا ذلك فأغلبه قابل للمناقشة([80]). وسبق لأستاذه الأنصاري أن إحتمل بأن الشرع لم ينصّب في حق المقلّد الطريق الخاص له كما يتمثل بفتوى المجتهد، معتبراً أن رجوعه إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان جميع العقلاء. لذلك حَسِبَ أن بعض ما ورد من الشرع في هذا الباب إنما هو من باب التقرير لا التأسيس([81]). ورأى الشيخ المنتظري أنه قد إستقرت سيرة الأصحاب في عصر النبي والأئمة على رجوع الجاهل للعالم والإستفتاء منه والعمل بما سمعه من الخبير الثقة. فهذا الرجوع يعود – برأيه – إلى حكم العقل لا أنه تقليد تعبدي، مادام الملاك في بناء العقلاء هو حصول الوثوق الشخصي. بمعنى أن العمل يتحقق بالوثوق الذي هو علم عادي تسكن به النفس لا بالتقليد ولا بالتعبد. ومن ثم ينتهي الى أنه ليس هناك ما يثبت التعبد بحجية قول الفقيه مطلقاً أو بشكل منقطع عن الوثوق الشخصي([82]). لكن سبق أن عرفنا بأن رجوع الناس إلى العلماء كما هو مقرر في الشريعة في عصر النبي والأئمة ليس هو التقليد الذي يقتضيه الإجتهاد، بل ما أُصطلح عليه الإتباع، وهو الوثوق الشخصي بتحصيل العلم من العالم. فقياس ذلك الباب على هذا الباب كما هو الجاري عند أغلب المتأخرين فيه مفارقة. كما أن قياس علم الشريعة على سائر العلوم والصنعات الإنسانية الأُخرى فيه مفارقة أيضاً؛ من حيث أنها – كما عرفنا – لا تقر صور الإجتهاد المفضية إلى الظن ولا التقليد القائم عليها، ما لم يكن ذلك على نحو الإضطرار؛ لإنسداد باب العلم ولا سبيل إلى تحصيل الأحكام إلا بالإجتهاد المفضي إلى الظن غالباً
[ 13 ]
أما عامة الناس فلا يقتضي عجزهم عن الإجتهاد أن يكونوا مقلّدين، ذلك أنهم على مستويين؛ فمنهم العاجز كلياً وهو لا سبيل إليه إلا التقليد، ومنهم من بوسعه النظر في الأدلة ولو على نحو الإجمال، وهذا ما لا يجوز عليه أن يقلّد مادام بوسعه الترجيح بين الأدلة والأخذ بأقواها أو بما تطمئن إليه نفسه. يبقى اننا نؤيد القول بأن بناء العقلاء الذي يحصل منه الوثوق الشخصي أو الإطمئنان لا يعد تقليداً، سواء عملنا به في الشرعيات او في غيرها، كما انه ليس مأخوذاً من باب التعبد. فمن الواضح أن هذا السلوك هو سلوك طريقي وأن حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل وتأسيس من الشرع
ـ[ 1] البحر المحيط، ج 6، ص. 270 وإرشاد الفحول، ص 265 . [ 2] الإحكام للآمدي، ج 4، ص. 445 [ 3] إرشاد الفحول، ص. 265 [ 4] معالم الدين، ص. 385 [ 5] انظر: الإجتهاد والتقليد للخوئي، ص 77 . 79 والكفاية، ص. 539 ومعالم الدين، ص. 385 ومنتهى الأُصول، ج 2 ، ص. 631 وعناية الأُصول، ج 6 ، ص 214 . 215 [ 6] الإجتهاد والتقليد، ص 77 . 79 [ 7] الحكيم، محسن الطباطبائي: مستمسك العروة الوثقى، مطبعة الآداب في النجف، الطبعة الرابعة، 1391 ه، ج 1، ص. 11 [ 8] حجة الله البالغة، ج 1، ص 153
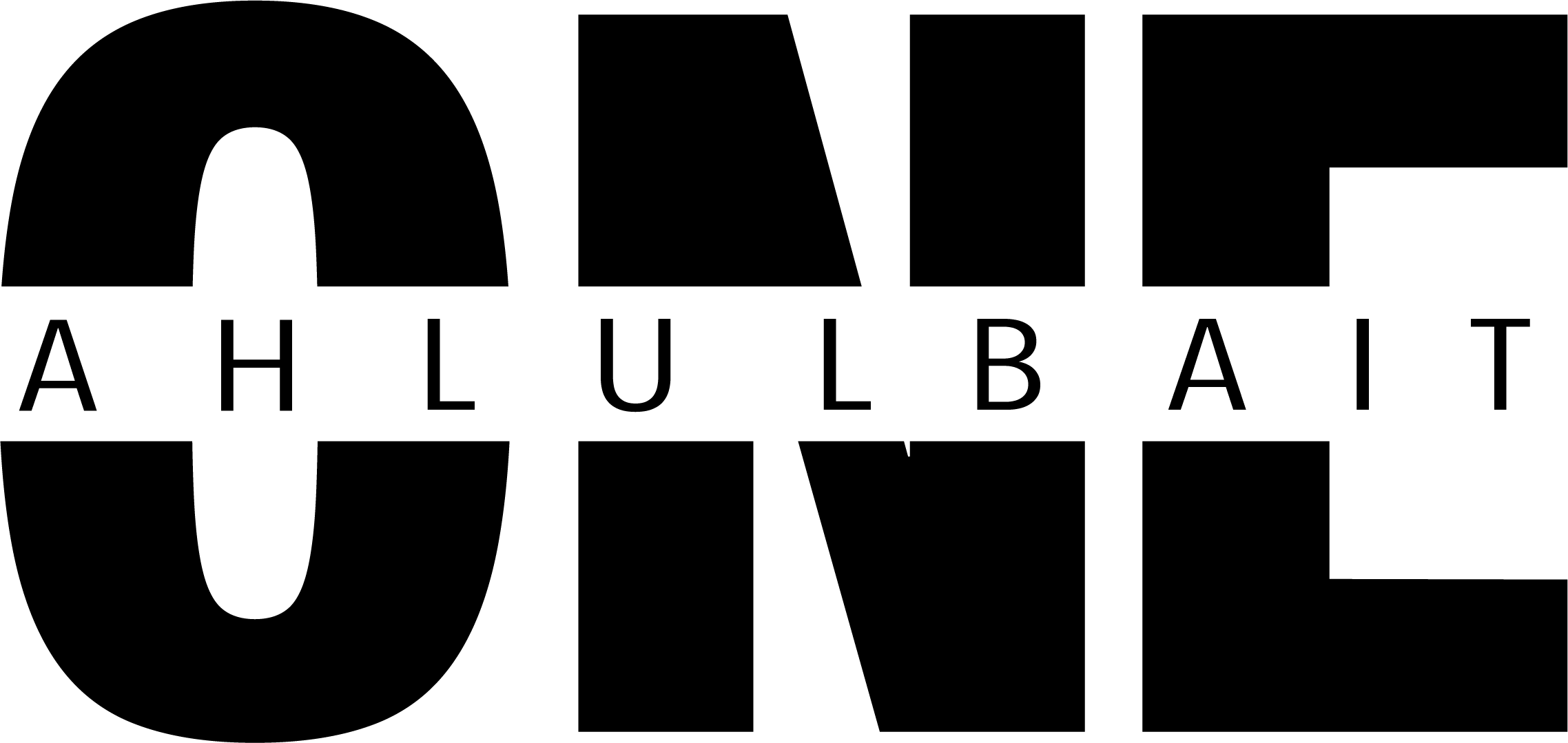
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.